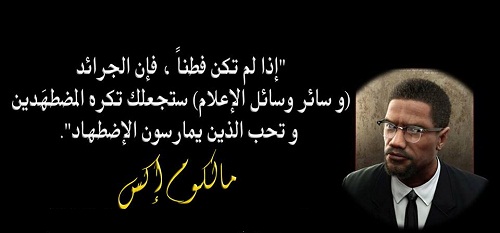إن جسم الإنسان يرتكز على العمود الفقري، وإن أي خلل يصيب هذا العمود ينعكس سلبًا على الجسد، فقد يؤدي ذلك إلى شلل في الجسم، كذلك هم الشباب، فإنهم عنصر الارتكاز أو العمود الفقري للمجتمع، فإذا ما نظرنا للمجتمعات المتقدمة فإننا نرى كيف اهتموا بالشباب فتتطورا وتقدموا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه في شتى المجالات.
إن المهتم بالشأن العربي يرى الحال الذي وصلنا إليه، فقد اختلفنا عن الأمم الأخرى، حيث كانت الأمم والشعوب الأخرى في حالة من الحروب والفوضى والظلام لكنها استطاعت أن تخرج من هذا الحال إلى حال أفضل، فقد تقدموا في الصناعة وعملوا على السيطرة على المنتجات والتسويق وتقدموا في التكنولوجيا والسياسة والعسكرية، لكن في المقابل فإن العرب الذي كانوا قبل فترة من الزمن لهم الفضل في الكثير من العلوم وكانوا يصدرون العلوم إلى الغرب، ثم أصبحوا في تراجع كبير.
الشباب بين سياسات التفقير الممنهجة والحروب التي لا تجلب غير الخسائر والدمار، بين البطالة وبين تعطيل العقول عن التفكير، الشباب العنصر المُهمش في المجتمع العربي.
لو قمنا بعمل دراسة على الجيل الشاب لوجدنا أن الكثير من الشباب لم يلتحقوا بالجامعات وذلك لأنهم لا يملكون المال للالتحاق بالجامعة، فتراهم فقط يبحثون عن لقمة عيشهم التي ينالونها بعدما يذوقون الكثير من الذل والإهانة والمرار، ولو قمنا بعمل دراسة على جيل الشباب لوجدنا أن نسبة الخرِّيجين العاطلين عن العمل بازدياد مستمر، فالبطالة تفتك بالمجتمع العربي ولم تأتِ البطالة من فراغ بل جاءت نتيجة للفساد الموجود الذي أدلا إلى تعيين الشخص اللامناسب في المكان اللامناسب.
الثورة، هي كلمة نسمعها بشكل شبه يومي، هي فعل يقوم به البعض لتحقيق أهداف ما، قد تكون هذه الأهداف تخص العامة من الناس أو قد تصب في مصلحة فئة ما على حساب فئات أخرى، الثورة هي فعل بدأ في العالم العربي لكنه ابتعد عن الهدف وابتعد عن المضمون وفقدت الثورة كل شيء وفقد الثوار آمالهم وأهدافهم، في البِدء كان الهدف من الثورات أو ما سُمي بالربيع العربي هو تغيير وضع قائم واستبداله بوضع أفضل وهذا يعني مشاركة الشباب في مناحٍ شتى في الدولة وحصولهم على جزء من حقوقهم، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن كل شيء سيتغير وأن الثورة ستأتي بالحرب.
الحرب، لا تأتي إلا بالدمار، فالدول التي تشهد حالة الحرب الآن عادت عشرات السنين إلى الخلف، ولن تستطيع أن تعيد بناء نفسها إلا بوقت طويل جدًا، ولكن إن اللافت في الحرب أن الشباب هم وقودها مثلما كانوا وقودًا في حالة اللاحرب، فهم مَنسيون ومُهمشون، فالدول التي كانت تتبع سياسة التفقير والإذلال بحق السكان، أظهرت لنا في حالة الحرب أن ميزانيتها كدول هي ميزانية كبيرة تكفي لعمل مشاريع وبناء اقتصاد وحياة كريمة لشعبها.
إن أهم ما يمكن أن نستخلصه في النهاية أننا لو أهدرنا هذا المال على فئة الشباب لوجدنا أننا نتقدم كالدول الغربية وفي وضع السلم وبعيدًا عن القتل والدمار، ولوجدنا أن الشباب هم عنصر يمكن الاعتماد عليه لأنه جيل متعلم ويستطيع أن يحقق الكثير، لكن ذهبنا إلى الاتجاه الآخر، وألقينا هذه الأموال في حرب لا تُبقي ولا تذر.
كان الأَولَى بناء الإنسان والدولة، لا هدم الدولة وقتل الإنسان.

الشباب العربي بين ماضيه المُر ومستقبله الضائع بين الحرب والهجرة، بين الطموحات والأحلام وبين الخوف مما هو قادم، الشباب العربي الذي كان من الممكن الاعتماد عليه أصبحت هذه الفئة إما مُهجّرة في بلاد غير بلادها وإما تنتظر الموت، وإما أنها أصبحت تمتلك وقت فراغ كبير تقضيه في المقاهي أو على أرصفة الطرقات.
الذين اتخذوا من الحرب وسيلة لتحقيق أهدافهم ليتهم تفكروا للحظة وتوقفوا قبل أن يبدؤوا، لوجدوا أن البناء بالرغم من صعوبته هو أفضل من الهدم على الرغم من سهولته.
كان الأجدر أن تتجه الدول العربية إلى التنمية، لا أن تتجه إلى الصراعات الدائرة الآن بين الدول العربية، في المقابل لا أحد يخسر غير الشباب الذين تحطمت آمالهم على صخرة الواقع الأليم، وذهبت مع الريح حيث يكون الهلاك.
في النهاية عندما أتحدث عن الشباب فإنني لا أقصد الذكور فقط بل أقصد الذكور والإناث، فلكل واحد دوره في الحياة ولكل واحد هدف ومكان.
فلقد أثبتت الدراسات منذ عقود أن هناك علاقة طردية بين الفقر والمرض النفسي .. فكلما زادت نسبة الفقر، زاد المرض النفسي بشتى صوره وأهمها الاكتئاب والقلق و الفصام والوسواس القهري و الأدمان.
فبناء على المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الأطباء النفسيين العالمي المنعقد في اليابان و المنبثقعن منظمة الصحة العالمية فأن السبب الأول للأمراض النفسية، و التي تعتبر أكثر المشاكل الصحية انتشارا بالعالم في القرن الحادي والعشرين، هو الفقر.
أذا نظرنا للأسر الفقيرة في مجتمعنا فنلاحظ بأن الفقر والعوز وعدم تناسب الدخل الشهري مع عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها ليس بالتحدي الوحيد الذي تعاني منه، فالتفكك الأسري وغياب أحدى الوالدين أو معاناة أحدهم (غالبا الأب) من المرض النفسي أو الإدمان وضعف الروابط الاجتماعية أيضا من التحديات التي تعايشها تلك الأسر باستمرار. مما يجعل رعاية الأطفال نفسيا وتربويا والاهتمام بهم ومراقبتهم ليس من أولويات الوالدين أما بسبب ضعف الوعي لديهم أو بسبب انشغالهم بإطعام تلك الأفواه الصغيرة قبل التفكير بالاهتمام بتربيتها ومتابعتها.

لهذا عندما يعيش الطفل أغلب وقته بعيدا عن الرقابة الأسرية وعن التوجيه و الإرشاد الذي تقدمة المدرسة فأنه يبدأ بتبني ثقافة الشارع والتي تشجع السلوك المنحرف والعدواني والغير مقبول اجتماعيا وتصبح مصدرا للفخر ولإثبات الكفاءة والشجاعة فتنتشر ممارسة السرقة والتدخين وتعاطي المخدرات فيما بينهم.
وكما هو معروف بأن مرحلة الطفولة من أخطر مراحل النمو في حياة الإنسان حيث إن شخصية الإنسان تتشكل معالمها الأساسية سلبا أو ايجابيا في مرحلة الطفولة، بالتالي يجب الاهتمام بهؤلاء الأطفال وتامين كافة متطلبات وشروط النمو النفسي والعقلي والبدني والمعرفي السليم لهم حتى لا ينشأ لدينا جيل يعيش على هامش المجتمع ينتشر به البطالة والانحرافات السلوكية والجهل. فهؤلاء الأطفال هم جيل المستقبل و رجاله.